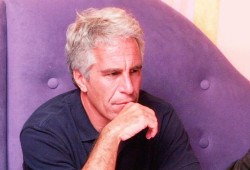تقدّم نيرمين علام، الزميلة غير المقيمة في برنامج الشرق الأوسط، قراءة سياسية تكشف كيف تُستَخدم قوانين الأحوال الشخصية كأدوات حكم وصراع على الشرعية والسلطة الأخلاقية في مصر والعراق. وتُظهر علام، عبر تحليل مكثّف لحراك المجتمعين، أن الجدل القانوني حول الأسرة يتجاوز حقوق النساء ليصل إلى قلب هندسة السلطة ذاتها.
خلفية المشهد القانوني والسياسي
يُبرز مصدر الدراسة، مؤسسة كارنيجي، كيف فجّرت جلسة برلمانية مضطربة في العراق خلال فبراير ٢٠٢٥ خلافاً واسعاً بعد دمج ثلاث مسودات في تصويت واحد شمل “قانون جعفري” يمنح رجال الدين الشيعة سلطة واسعة على قضايا الأسرة. ويدفع هذا الإطار الجديد نحو توسيع زواج القاصرات وتقليص سلطة القضاء وتعميق الفوارق الجندرية، وفق تحذيرات ناشطين. بعد شهور من الغموض، صادق البرلمان على الوثيقة بصيغة جرى نقاشها بين الوقفين السني والشيعي.
وفي مصر، عاد الجدل حول قوانين الأسرة عند تسريب مشروع حكومي عام ٢٠٢١ كشف بنوداً تحدّ من استقلال النساء وتمنح الآباء حق إبطال زواج بناتهم الراشدات وتعزّز ولاية الرجل. أحدث التسريب موجة احتجاج واسعة دفعت السلطات إلى سحب المشروع وصوغ نسخة معدّلة عبر لجنة قضائية. لكن النسخة الجديدة، المطروحة في ٢٠٢٥، حافظت على البنية الأبوية الأساسية رغم بعض التعديلات الشكلية
لماذا تعاند الأنظمة إصلاح قوانين الأسرة؟
يكشف التحليل أن الأنظمة في المنطقة لا ترفض الإصلاح فقط استناداً إلى اعتبارات دينية أو ضغط مؤسسات محافظة، بل لأنها تستفيد مباشرة من إبقاء بنية الأسرة تحت سيطرة أبوية. تسمح هذه البنية للسلطة بتحديد من يمتلك شرعية أخلاقية ومن يعرّف المواطنة ومَن يضبط أدوار النوع الاجتماعي. وتُظهر معطيات بحثية أن النظامين المصري والعراقي يوظفان القانون الأسري كأداة شرعية: مصر عبر ترسيخ المركزية والجمود، والعراق عبر منح سلطات دينية شيعية دوراً يوازن بين أحزاب الحكم والمرجعية.
وتنطلق الدراسة من مقابلات موسّعة أجرتها علام مع ناشطات وخبراء قانونيين في مصر، وتحليل لنصوص دستورية ومشاريع قوانين عدة. وفي العراق، اعتمد الفريق على تحليل الدستور وقانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٩ وتعديلاته، إضافةً إلى رصد حملات رقمية وتقارير حقوقية.
مصر… إدارة استراتيجية للتأجيل
يكشف الجانب المصري أن السلطة تواصل طرح مسودات محافظة أو تجميد المسارات الإصلاحية عندما يهدّد التغيير ركائز النظام. تُنظّم الدولة الإصلاح بحيث يعزّز سلطتها فقط، بينما تتجاهل مطالب النسويات المتعلقة بالطلاق، والولاية، والحضانة، وتعدد الزوجات، والعنف الأسري.
طرحت الحكومة مشروع ٢٠٢١ بنصوص توسّع ولاية الرجل وتمنح الآباء سلطة إلغاء زيجات بناتهم الراشدات، وتقصي الأمهات من ولاية الأطفال رغم وجودهن في الحضانة. أثار المشروع غضباً واسعاً، فأطلقت ناشطات حملة “الولاية حقي” لإبراز اختلالات النظام القانوني. شارك المجلس القومي للمرأة بدور محدود ركّز على “تنسيق قانوني” أكثر من تفكيك التمييز.
قدّمت منظمات مثل مركز قضايا المرأة المصرية مشاريع بديلة تطرح وضع الطلاق تحت سلطة القضاء، وتنظيم توزيع الممتلكات المشتركة، وضمان حق الزيارة، وتثبيت حق الأم المسيحية المتزوجة من مسلم في الحضانة. ومع ذلك، اعتمدت الدولة لاحقاً نسخة ٢٠٢٥ بصياغات “منمّقة” لا تمسّ صلب البنية الأبوية.
بذلك تُدير السلطة شرعيتها من دون التخلي عن سيطرتها؛ تُعطي إشارات استجابة، لكنها تترك جوهر الولاية الذكورية كما هو.
العراق… شرعية تفاوضية عبر المحافظة
يُظهر المشهد العراقي نموذجاً آخر؛ إذ تُمارس الأحزاب الشيعية الحاكمة سياسة “تفويض قانوني” للمرجعية الدينية عبر إقرار قانون جعفري يمنح سلطة واسعة للمؤسسة الدينية في شؤون الأسرة. يوفّر هذا التفويض مخرجاً سياسياً لحكومة تحتاج إلى بناء توافقات طائفية، لكنه يعمّق في الوقت نفسه الانقسام الطائفي ويزيد هشاشة حقوق النساء.
يعتمد هذا الاتجاه على تبنّي خطاب محافظ يُقدَّم كاستعادة للهوية المذهبية، بينما يخلق واقعاً قانونياً يضعف القضاء المدني ويعيد النساء إلى موقع خاضع داخل الأسرة
تكشف المقارنة بين مصر والعراق أن القوانين الأسرية ليست مسألة فقهية أو تقنية، بل ساحة صراع سياسي حول السلطة والشرعية والهوية. تُظهر التجربتان أن أي إصلاح لا ينطلق من إشراك النساء بفاعلية ولا يواجه البنى الأبوية العميقة سيعيد إنتاج عدم المساواة مهما بدا حديثاً أو “تقدمياً”.
ينفتح النقاش بعد ذلك على سؤال أكبر: كيف يمكن إعادة تخيّل سلطة قانون الأسرة بحيث تضع العدالة لا الهيمنة في المركز؟ هذه هي العقدة التي سيستمر الجدل حولها في المنطقة لسنوات طويلة.
https://carnegieendowment.org/research/2025/11/the-politics-of-personal-status-law-in-egypt-and-iraq?lang=en